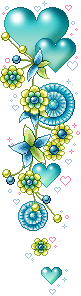الفرق بين الزوجة و المرأة في القرآن الكريم — تبهرني العقول المتفتحة التي تفسر لنا ما لا ندركه من كلام الخالق جل شأنه
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
تعالوا وتعرفوا على البلاغة في القران والدقة في التعبير والبيان
ثم قولوا سبحانك ياعظيم يامنان
متى تكون المرأة زوجاً ومتى لا تكون ؟
عند استقراء الآيات القرآنية التي جاء فيها اللفظين ، نلحظ أن لفظ
"زوج" يُطلق على المرأة إذا كانت الزوجية تامّة بينها وبين زوجها
وكان التوافق والإقتران والإنسجام تامّاً بينهما ، بدون اختلاف ديني أو
نفسي أو جنسي ..
فإن لم يكن التوافق والإنسجام كاملاً ، ولم تكن الزوجية متحقّقة بينهما ،
فإن القرآن يطلق عليها "امرأة" وليست زوجاً ، كأن يكون اختلاف
ديني عقدي أو جنسي بينهما ..
ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى : "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ" ، وقوله تعالى : "وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ
أَزْوَاجِنَاوَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا" .
وبهذا الإعتبار جعل القرآن حواء زوجاً لآدم ، في قوله تعالى : "وَقُلْنَا يَا
آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ" . وبهذا الإعتبار جعل القرآن نساء النبي
صلى الله عليه وسلم"أزواجاً" له ، في قوله تعالى : "النَّبِيُّ أَوْلَى
بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ" .
فإذا لم يتحقّق الإنسجام والتشابه والتوافق بين الزوجين لمانع من الموانع
فإن القرآن يسمّي الأنثى "امرأة" وليس "زوجاً" .
قال القرآن :امرأة نوح،وامرأة لوط، ولم يقل :زوج نوح أو زوج لوط،
وهذا في قوله تعالى : "ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ
لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا" .
إنهما كافرتان ، مع أن كل واحدة منهما امرأة نبي ، ولكن كفرها لم يحقّق
الإنسجام والتوافق بينها وبين بعلها النبي . ولهذا ليست "زوجاً"
له ، وإنما هي "امرأة" تحته .
ولهذا الإعتبار قال القرآن :امرأة فرعون، في قوله تعالى : "وَضَرَبَ اللَّهُ
مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُواِمْرَأَةَفِرْعَوْنَ" . لأن بينها وبين فرعون مانع من الزوجية ،
فهي مؤمنة وهو كافر ، ولذلك لم يتحقّق الإنسجام بينهما ، فهي "امرأته"
وليست "زوجه" .
ومن روائع التعبير القرآني العظيم في التفريق بين "زوج" و"امرأة"
ما جرى في إخبار القرآن عن دعاء زكريا ، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة
والسلام ، أن يرزقه ولداً يرثه . فقد كانت امرأته عاقر لا تنجب ، وطمع
هو في آية من الله تعالى ، فاستجاب الله له ، وجعل امرأته قادرة على
الحمل والولادة .
عندما كانت امرأته عاقراً أطلق عليها القرآن كلمة "امرأة" ،
قال تعالى على لسان زكريا : "وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن
لَّدُنكَ وَلِيًّا" . وعندما أخبره الله تعالى أنه استجاب دعاءه ،
وأنه سيرزقه بغلام ، أعاد الكلام عن عقم امرأته، فكيف تلد وهي عاقر ،
قال تعالى : "قَالَ رَبِّ أَنَّىَ يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي
عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاء" .
وحكمة إطلاق كلمة "امرأة" على زوج زكريا عليه السلام أن
الزوجية بينهما لم تتحقّقفي أتمّ صورها وحالاتها ، رغم أنه نبي ، ورغم أن
امرأته كانت مؤمنة ، وكانا على وفاق تامّ من الناحية الدينية الإيمانية .
ولكن عدم التوافق والإنسجام التامّ بينهما ، كان في عدم إنجاب امرأته ،
والهدف"النسلي" من الزواج هو النسل والذرية ، فإذا وُجد
مانع بيولوجي عند أحد الزوجين يمنعه من الإنجاب ، فإن الزوجية لم
تتحقّق بصورة تامّة .
ولأن امرأة زكريا عليه السلام عاقر ، فإن الزوجية بينهما لم تتمّ
بصورة متكاملة ، ولذلك أطلق عليها القرآن كلمة "امرأة" .
وبعدما زال المانع من الحمل ، وأصلحها الله تعالى ، ولدت لزكريا ابنه يحيى ،
فإن القرآن لم يطلق عليها "امرأة" ، وإنما أطلق عليها كلمة
"زوج" ، لأن الزوجية تحقّقت بينهما على أتمّ صورة . قال تعالى :
"وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ *
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ" .
والخلاصة أن امرأة زكريا عليه السلام قبل ولادتها يحيى هي "امرأة"
زكريا في القرآن ، لكنها بعد ولادتها يحيى هي "زوج"
وليست مجرّد امرأته .
وبهذا عرفنا الفرق الدقيق بين "زوج" و"امرأة"
في التعبير القرآني العظيم ، وأنهما ليسا مترادفين…
سبحان الله